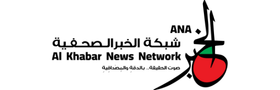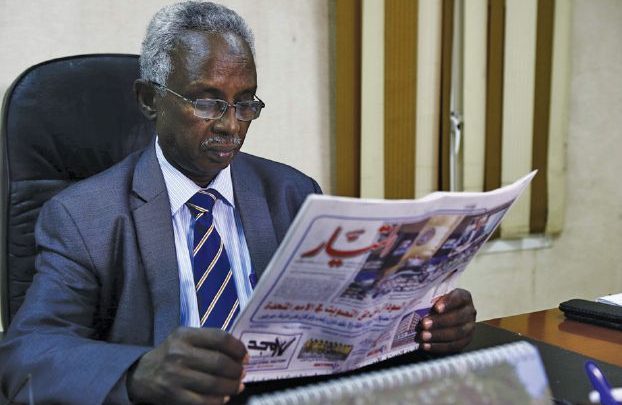سميح جمال يكتب : الحركة الإسلامية السودانية والإخوان المسلمون: كيانان مختلفان ومساران متباينان

التحول من صراع على السلطة إلى صراع على النجاة
سميح جمال
في النقاش السوداني الراهن، يُستخدم مصطلح “الإخوان المسلمين” بوصفه توصيفًا جامعًا لكل ما هو إسلامي سياسي، دون تمييز بين التنظيمات، أو السياقات، أو التجارب التاريخية.
في الحالة السودانية، يعتبر هذا التعميم، رغم شيوعه، يتجاهل حقيقة أساسية مفادها أن الحركة الإسلامية لم تكن، في أي مرحلة حاسمة من تاريخها الحديث، فرعًا تابعًا لجماعة الإخوان المسلمين، بل كيانًا سياسيًا محليًا تشكل وفق شروط الدولة السودانية وصراعاتها الخاصة.
وقبل أن نربط ما بين هذا الموضوع ومجريات الأحداث في البلاد والتي تسعى فيها أطراف سياسية إلى إطالة أمد الأزمة السودانية وزيادة تأزيم الأوضاع بالركض لمحاولة تصوير الحركة الإسلامية باعتبارها الاخوان المسلمين في السودان لتحظى هذه الأطراف بتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية ضمن المشروع الغربي، علينا تناول بعض ما هو متصل بما تم من تحول وتغييرات في تكوين الحركة الإسلامية، فمنذ ستينيات القرن الماضي، بدأت البذور الأولى للاختلاف بين الإسلاميين في السودان والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. فبينما حافظت الجماعة الأم على طابعها الدعوي والتنظيمي العابر للحدود، اتجه التيار الإسلامي السوداني، بقيادة حسن الترابي لاحقًا، إلى إعادة تعريف العمل الإسلامي بوصفه مشروعًا سياسيًا سلطويًا يستهدف الدولة مباشرة، لا المجتمع بوصفه مجالًا إصلاحيًا طويل الأمد.
وبلغ هذا الاختلاف ذروته في مطلع الثمانينيات، عندما أعيد تأسيس “الجبهة الإسلامية القومية” كتنظيم سياسي مستقل، منفصل تنظيميًا عن الإخوان المسلمين، وغير خاضع لهياكلهم الدولية أو لمرجعيتهم القيادية. منذ تلك اللحظة، لم يعد التنظيم الإسلامي السوداني يعمل ضمن شبكة الإخوان، بل أصبح كيانًا سيادي القرار، يضع أولوياته وفق معادلات الداخل السوداني، لا وفق أجندة الحركة العالمية.
الفارق الجوهري الثاني يتمثل في الموقف من السلطة. فجماعة الإخوان المسلمين، رغم تقلباتها السياسية، ظلت تاريخيًا تميل إلى العمل التدريجي داخل المجتمع، وتتحفظ على الانقلابات العسكرية بوصفها مسارًا غير مضمون الشرعية والاستدامة. في المقابل، اختارت الحركة الإسلامية السودانية خيار الانقلاب العسكري في عام 1989، وتحملت وحدها تبعات هذا القرار السياسية والأخلاقية، بما في ذلك عسكرة الدولة، وتسييس المؤسسات، وربط الدين مباشرة بسلطة الحكم.
ومع وصولها إلى الحكم، لم تُدر الحركة الإسلامية الدولة بعقل تنظيم دعوي، بل بعقل حزب حاكم. ومع مرور السنوات، تلاشى الفارق بين الحركة والنظام، وتحولت إلى بنية سلطوية متشابكة مع الجيش والأمن والاقتصاد، وهو مسار لا يشبه — من حيث الطبيعة أو النتائج — تجربة الإخوان المسلمين في أي بلد آخر.
تتجلى الفروق أيضًا في البنية الفكرية. فالأجيال التي تربت داخل مؤسسات الدولة خلال حكم الإنقاذ لم تتلقَّ تكوينها على أدبيات الإخوان الكلاسيكية، بل على خطاب تعبوي براغماتي، يوظف الدين لتبرير السلطة، لا لبناء مشروع إصلاحي أخلاقي. وقد انعكس هذا التحول بوضوح في الصراعات الداخلية التي انتهت بمفاصلة 1999، وهي أزمة داخلية للحركة الإسلامية نفسها، لا علاقة لها بالإخوان المسلمين تنظيمًا أو قرارًا.
أما على المستوى الدولي، فإن ربط العقوبات وتصنيفات الإرهاب بالحركة الإسلامية السودانية على أساس “الإخوان” يفتقر إلى الدقة. فالعقوبات الأمريكية فُرضت لأسباب تتعلق باستضافة جماعات جهادية عابرة للحدود، وبسلوك النظام الإقليمي والدولي، لا بانتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين، وهو فارق جوهري في التوصيف القانوني والسياسي.
اليوم، وبعد سقوط نظام الإنقاذ، يُعاد إنتاج الخلط ذاته في الخطاب السياسي والإعلامي، حيث تُختزل أزمة الدولة السودانية في “الإسلاميين” بوصفهم كتلة واحدة، دون تفريق بين التنظيم، والنظام، والمجتمع. هذا الخلط لا يساعد على العدالة، ولا يقود إلى محاسبة حقيقية، بل يفتح الباب أمام إقصاء شامل يعيد إنتاج الصراع بدل حله.
إن الفصل بين الحركة الإسلامية السودانية وجماعة الإخوان المسلمين لا يتجاوز أبدًا ما وقع على البلاد من انتهاكات وتعديات وظلم، ولا يناصر تجربة حكم فشلت، لكنه خطوة ضرورية لفهم الواقع كما هو، لا كما نرغب أن يكون. ففي السياسة، كما في التاريخ، تُبنى الدول على التشخيص الدقيق، والتمييز الصارم بين المفاهيم، والمسؤوليات، والكيانات.
وبالعودة إلى الربط بين أهداف هذا المقال، نقف عند ما يحدث من تحولات جرت خلال فترة الحرب، فمنذ اندلاع الحرب في السودان، لم تعد المعركة عسكرية فقط، بل تحولت إلى ساحة صراع مخابراتي بامتياز وإعلامي بمنهجية متقنة، تُستخدم فيها المفاهيم السياسية كسلاح لا يقل فتكًا عن المدافع. وفي مقدمة حرب المعلومات والكلام هذه، يبرز الخلط المتعمد عند بعض الأطراف والكسول عند آخرين بين الحركة الإسلامية السودانية وجماعة الإخوان المسلمين، بوصفه أحد العوامل التي تعقّد الأزمة وتطيل أمد الحرب، بدل أن تفتح الطريق نحو تسوية سياسية ممكنة.
ونفهم الآن أن الحركة الإسلامية السودانية، بوصفها تنظيمًا سياسيًا محليًا تشكّل وفق سياق الدولة السودانية، ليست كيانًا مطابقًا لجماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا أو قيادة أو ارتباطًا دوليًا؛ وهذا يطرح سؤال لماذا تستمر أطراف سياسية في ممارسة الدور الكيدي بأن تصنف النظام السابق وحركته الإسلامية باعتبارهم الاخوان المسلمين، وبالرغم هناك أطراف إسلامية أخرى تبقى ضمن قوى الثورة السودانية كما تدعي ذات الأطراف؟
وفي سياق الحرب، تحوّل هذا الخلط إلى أداة تعبئة. فتصوير الصراع بوصفه مواجهة مع “الإخوان المسلمين” يمنح الحرب بعدًا أيديولوجيًا عابرًا للحدود، ويُدخل السودان في معركة تصنيفات إقليمية ودولية لا تخدم أولويات وقف النار أو حماية المدنيين. كما أنه يدفع أطرافًا داخلية إلى التصلب، خوفًا من الإقصاء الشامل، ويغلق أي نافذة لحوار سياسي واقعي.
أزمة ملاحقة الحركة الإسلامية تحت لافتة “الإخوان” لا تقتصر آثارها على الخطاب، بل تمتد إلى بنية الصراع نفسه. فعندما تُصنّف كتلة اجتماعية وسياسية واسعة — تضم تيارات مختلفة، بعضها مندمج في الدولة، وبعضها منسحب من العمل العام — بوصفها عدوًا أيديولوجيًا واحدًا، يتحول الصراع من نزاع سياسي قابل للحل إلى معركة وجودية، تُدار بمنطق الكيد والانتقام، لا بمنطق التسوية.
هذا المسار يعيد إنتاج أخطاء ما قبل الحرب. فبدل تفكيك إرث الدولة السلطوية عبر العدالة الانتقالية والمؤسسات، يُستبدل ذلك بإقصاء سياسي جماعي، يدفع الفاعلين إلى الاحتماء بالسلاح أو التحالف مع مراكز قوة عسكرية، باعتبارها الضامن الوحيد للبقاء. وهنا تتحول الحرب من صراع على السلطة إلى صراع على النجاة، وهو أخطر أشكال الحروب وأكثرها طولًا.
كما أن ربط الحرب السودانية بصراع إقليمي مع جماعة الإخوان المسلمين يضعف فرص الدعم الدولي للحل السياسي. فالدول الفاعلة لا تتعامل مع الأزمات بوصفها نزاعات فكرية، بل وفق حسابات الاستقرار والمصالح. وعندما يُقدَّم السودان كساحة مواجهة أيديولوجية، تتراجع فرص الضغط الجاد لوقف الحرب، ويتحول البلد إلى ملف ثانوي في صراعات أكبر.
إن الإصرار على توصيف الحركة الإسلامية باعتبارها “الإخوان المسلمين” لا يخدم ضحايا الحرب، ولا يقرّب العدالة، ولا يبني دولة جديدة. بل يطيل أمد الصراع عبر تعقيد تعريف العدو، وتوسيع دائرة الخصومة، وإغلاق الباب أمام أي تسوية سياسية شاملة. فالحروب لا تنتهي بإلغاء المكونات الاجتماعية، بل بإعادة تنظيم العلاقة بينها ضمن دولة قانون.
وفي اعتقادي إن الفصل بين التنظيمات، وتحديد المسؤوليات الفردية، وبناء مسار عدلي مستقل، هي الشروط الضرورية لإنهاء الصراع. أما استمرار الخلط، وملاحقة الكيانات تحت عناوين أيديولوجية فضفاضة، فلن ينتج سوى حرب أطول، وكلفة إنسانية أفدح، ومستقبل أكثر هشاشة.
وفي اعتقادي إن الفصل بين التنظيمات، وتحديد المسؤوليات الفردية، وبناء مسار عدلي مستقل، هي الشروط الضرورية لإنهاء الصراع. أما استمرار الخلط، وملاحقة الكيانات تحت عناوين أيديولوجية فضفاضة، فلن ينتج سوى حرب أطول، وكلفة إنسانية أفدح، ومستقبل أكثر هشاشة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحفي ومحلل سياسي