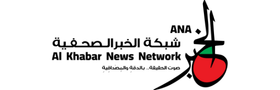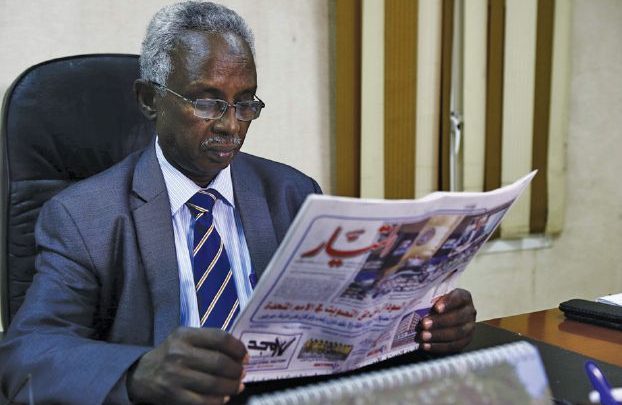عبداللطيف البوني يكتب: مشروع الجزيرة: إرث الإنجليز أم مأساة السودنة ؟

حاطب ليل
ثمة ضحايا للتاريخ، ومن ضمنهم مشروع الجزيرة، لا بل قد يكون في طليعتهم. في ظني أنه لا يوجد مشروع لازمتْه ظروف نشأته لعقود من الزمان، أو كبله تاريخه ومنعه من المواكبة والتطور والانطلاق، مثل مشروع الجزيرة. دعونا نثبت هذه الفرضية من خلال الإدارة في مشروع الجزيرة. ولكن قبل أن ندلف إلى ذلك الأمر، علينا أن نقر بأن المشروع صناعة بريطانية مئة المئة، وقد صُمم لخدمة أهداف بريطانية بنفس النسبة، وقد حقق المطلوب منه أيضًا بذات النسبة. فقد قام على أحدث ما وصلت إليه تقانات ذلك الزمن، وطبقت فيه سياسات ملبية لتلك الأهداف المطلوبة.
بعد ذهاب البريطاني المستعمر، ترك للسودانيين المشروع بكل إمكانياته المادية والتقنية. كان ينبغي أن تتغير الأهداف لتلائم حاجة البلاد التي أصبحت مستقلة، وبالتالي تتغير السياسات، وبالتالي تتغير التدابير الإدارية القائمة. ولكن للأسف، ظلت ثابتة على ما هي عليه. لماذا؟ هذا ما نحن بصدده في هذه السلسلة من المقالات.
الهدف الأساسي من المشروع كان إنتاج القطن طويل التيلة لتغذية مصانع لانكشير بالمادة الخام، وعلى هذا الأساس تم وضع قوانين تعالج قضية الأراضي من حيث الملكية والمنفعة وتوزيعها وتقطيعها إلى أقسام، وتفاتيش، وقنوات، وحواشات، وكل الذي منه، وعلاقات الإنتاج. وحددت الإدارة العليا ثم الإدارة المباشرة، وكانت هذه الإدارة في غاية المركزية، لابل مركزية في غاية الصرامة.
الإداريون من قمتهم في بركات، أي الخواجات أنفسهم، إلى أصغر غفير ترعة، ما عليهم إلا تنفيذ الأوامر، ومن باب أولى أن يكون المزراعون كذلك. باختصار، كل منسوبي المشروع خواجات على عمال، على مزارعين، حدودهم تنفيذ المطلوب منهم دون أي مساءلة. أما الأوامر فهي تأتي من لندن، حيث رئاسة الشركة التي تعرف اختصارًا بـ “السندكيت”، إلى بركات، مباشرة دون المرور بالخرطوم أو مدني. نزول الماء في القنوات الرئيسية، ومنها للفرعية، رمي البذور، الحش، الرش، الحصاد، التسليم، صرف الاستحقاقات والأرباح… كلها محددة بجدول زمني منضبط.
بالتالي لم تكن هناك حاجة لمختصين في الزراعة أو الاقتصاد أو الهندسة، أو حتى إدارة الأعمال. لذلك كان الإداريون الإنجليز الأوائل معظهم ضباط جيش سابقون، والكبار منهم خريجو كليات نظرية. فمستر أرثر جيتسكل، أشهر إداري بريطاني، بدأ عمله في المشروع من مفتش غيط صغير، إلى أن وصل محافظ المشروع، وكان خريج آداب تاريخ.
قسم المشروع إلى أقسام، وقسم الأقسام تفاتيش، ثم تفاتيش فرعية، وفي كل تفتيش فرعي مفتش، وهو الذي يباشر العمل على المزارع، ويقيم في سرايا غناء بعيد عن قرى المزارعين. وفوقه الباشمفتش، الذي يقيم في سرايا أكبر بها المخازن والحسابات، في الجزيرة يقولون لها “مكتب”. يخضع المفتش للباشمفتش، والباشمفتش يخضع لمدير القسم، الذي بدوره يتلقى الأوامر من المحافظ. كلمة “تفتيش” و”مفتش” هي ترجمة للكلمة الإنجليزية Inspector، فهو ليس مبتدعًا، إنما عليه التأكد من التنفيذ. فمفتش التعليم مثلاً لا يدرس، إنما عليه التأكد بأن المدرس نفذ المطلوب منه وفق المنهج المقرر.
بعد خروج الشركة الإنجليزية حصلت السودنة، فجاء الإداريون السودانيون بنفس مواصفات الخواجات، أي غير مختصين في الزراعة ولا في الاقتصاد. فأول محافظ سوداني لمشروع الجزيرة هو مكي عباس، معلم جاء للوظيفة من بخت الرضا حيث كان مسؤولًا عن تعليم الكبار. أما المفتشون المباشرون، فبعضهم كان مدرسًا، وبعضهم مرافيد جيش، مثل الشاعر الرقيق الطاهر إبراهيم، حيث كان ضابطًا في القوات المسلحة وقام بانقلاب فاشل، وبعد سجن قصير عُين مفتشًا بمشروع الجزيرة في مكتب الفوار. وهناك ألف بعض أغانيه ولحنها لإبراهيم عوض، مثل أغنية “يا خائن”، وكانت للذي وشى بالانقلاب لسلطات عبود، ومثل أغنية “فارقيهو دربي واخليهو قلبي… أحلامك أحلام ما بحلم بيها… دنياك دنيا غير العايش فيها”. إبداع ياخي يا الطاهر! بالله شوفوا “اخليهو قلبي”، رغم عسكريتها جاءت حلوة كيف! ملاحظة غير هامة وهي أن معظم المفتشين الأوائل في مشروع الجزيرة كانوا من أولاد أم درمان.
لكن المشكلة كانت أين؟ في عهد الخواجات، كما ذكرنا، كانت الأوامر تأتي من لندن، وفي لندن كان القرار يُصنع بعد دراسة وتمحيص من التقارير التي تأتي من ذات المشروع ومن المشاريع في المستعمرات الأخرى. أحيانًا تُبعث الشركة بباحثين زراعيين ومهندسين للجزيرة، ويرفعون نتائج دراستهم للشركة، فيُصنع القرار ثم يُتخذ ويُرسل إلى بركات للتنفيذ دون أي سؤال. أما بعد السودنة، فانقطع الإمداد من لندن، والخرطوم كانت مشغولة بسياسة وصراع على السلطة، فوُكل أمر المشروع للإداريين الذين حلوا محل الخواجات، وهم ليسوا زراعيين ولا اقتصاديين ولا مختصين في إدارة الأعمال.
وقد لخص هذا الوضع الدكتور توني بارنيت في كتابه القيم (مشروع الجزيرة… وهم تنموي) على حسب ترجمة صديقنا الدكتور عبد اللطيف سعيد، والذي كان ردًا على كتاب أرثر جيتسكل (مشروع الجزيرة… قصة تنمية). ورغم المفارقة في عنواني الكتابين، فقد كان الخواجتان صادقين كل فيما ذهب إليه؛ فبارنيت نظر لإنسان الجزيرة الذي كان ساعة دراسته في غاية البؤس والشقاء والتخلف، وجيتسكل نظر للأرض كيف أنها تحورت من أرض بور بلقع إلى منتج لأعظم محصول نقدي في العالم يومها، وهو القطن.
عودة إلى موضوعنا، وإن لم نخرج عنه، فقد وصف بارنيت الإداري والمفتش السوداني بأنه ورث من الخواجة الوظيفة المجزية والسراية والتعالي على المزارع، وبالتالي كان مصممًا على المحافظة على السيستم القائم، رافضًا لأي تغيير. كان هؤلاء الإداريون شرسين جدًا في مقاومة أي تغيير، وعلى حسب الاستطلاع الذي أجراه بارنيت نفسه، فإن أكثر من تسعين في المئة كانوا رافضين لأي سياسة جديدة، فكان التكلس وكان البوار.
فيما بعد حاولت الحكومات المتعاقبة، خاصة في عهد نميري، زحزحة المشروع من الوضع الذي تركه عليه الإنجليز، وذلك بإدخال محاصيل جديدة، وعلاقات إنتاج جديدة، وتعيين خرّيج زراعة كمفتشين وخريجي اقتصاد في إدارة المشروع. ولكنها للأسف كانت تغييرات كمية وليست نوعية، فلم تنقل المشروع النقلة المطلوبة، وظل ما ورث عن الإنجليز في معظمه قائمًا إلى يوم الناس هذا.
وفي المقال القادم، إن شاء الله، سنتطرق إلى “المزارع”، وهو الآن سبب البلاء والابتلاء، لنصل إلى خلاصة أن المشروع محتاج لمئات الآلاف من الزراعيين المختصين، ومزارعين يعرفون قيمة ما تحت أيديهم من كنوز وسلطات، فهم روح وريحان ومحور المشروع. فالمفتش ومندوب المزارعين هما العلة، ليس في شخصهما، بل في طبيعة المؤسسة (Establishment).
حتى لا تُفهموا غلطًا، فنحن لسنا ضد الإداريين ولا المفتشين ولا ممثلي المزارعين، فهم ناس عاديون، نواياهم حسنة ومفطورون على حب الخير. نحن ندعو إلى صلاح المؤسسة، لكي يؤدي كل واحد منهم دوره فيما يفيد البلاد والعباد. فمثلاً، تغيير العربات من الموريس الماينر الذي كان يركبه المحافظ إلى امتطاء الليالي العلوية، وتغيير أثاثات المنازل والمكاتب، والعلاج بالخارج، وكل الذي منه، كلها فساد في فساد، ولكن فساد مؤسسي لا يعاقب عليه فرد، كله بالقانون. فطريقة حساب التكلفة الإدارية كانت باينة التطفيف.
بالتأكيد ليس فيما نقول القول الفصل، بل هي مجرد وجهة نظر قابلة للحذف والإضافة، للأخذ والرد، لابل الرمي في وجه صاحبها. فالمهم أن يتواصل الحوار حتى نصلح الحال. كلنا متفقون أن حال المشروع لا يسر صديقًا ولا عدواً، ولابد من استعدال الحال المائل. لذلك سنظل ندندن إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، فـ “المراويد هدن جبل الكحل”.