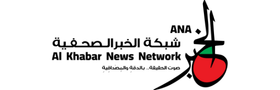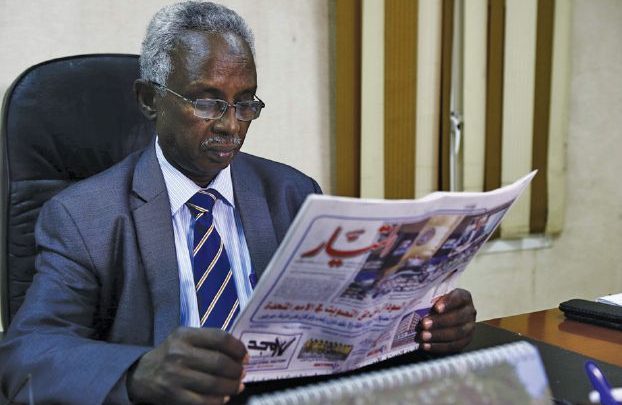كتاب: سليم أغا: ملحمة أحد ضحايا الاسترقاق (2/2)

تقديم بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
تأليف جيمس مكارثي، ترجمة ياسر عَـبِـيدِى بَرْدَويل، 2024
المذكرات الملهمة وسكب الذات
سكب المترجم ياسر ذاته في هذه المذكرات، وكذلك فعل المؤلف ماكارثي. لم تكن حياة سليم الملهمة ومذكراته المشرفة، عملاً علمياً فحسب، لدى ياسر، وإنما تعاطى معها باعتبارها واجباً ثقافياً ووطنياً، ومهمة إنسانية وأخلاقية.
ففي الأصل لم يكن ياسر مترجماً محترفاً، وإنما باحثاً في شؤون السودان وأفريقيا، ومهتماً بقضايا التنوع الثقافي. تعود جذوره إلى نوبة الشمال (عبري/ تبج)، وهو من مواليد الرّهد بغرب السودان. كان والده (1820- 1984) من رواد الحركة الوطنية السودانية، دخل السجن، وقاد النضال ضد الاستعمار. تخرج في المدارس الصناعية، وعمل في هيئة سكك حديد السودان. كان عضواً في مؤتمر الخريجين الذي تأسس عام 1938، ثم أصبح أول سكرتير لهيئة شؤون عمال هيئة سكك حديد السودان. تشرب ياسر هذا التراث الوطني للأسرة، ونشأ وأمام عينيه مكتبة حافلة بالكتب ووثائق الحركة الوطنية والحركة العمالية. تلقى تعليمه حتى المرحلة الثانوية في مدارس الخرطوم العاصمة. ثم غادر إلى المملكة المغربية للدراسة الجامعية. كان في وداعه بمطار الخرطوم والده، الذي انتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى، ليكون ذلك هو الوداع الأخير لابنه. تخرّج ياسر في كليّة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الملك محمّد الخامس، الرباط، (1988). ثم دفعه انشغاله بقضايا التراث والفلكلور، إلى الالتحاق بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، بجامعة الخرطوم، ليحصل على دبلوم الفولكلور في العام 2020. ظل ياسر فاعلاً في الحوار والحراك حول شؤون السودان والإنسان. نشر العديد من المقالات في صحفية الأيام، بالخرطوم، وغيرها من الصحف والمجلات، كما نشر العديد من المساهمات في المنابر الحوارية، فضلاً عن الترجمات لقضايا متنوعة.
يتميز أداء ياسر، سواء في الكتابة أو الترجمة أو الحوار، بالعلمية والدقة والإتقان والعمل بمحبة. وقفت على ذلك من خلال العلاقة الخاصة، وعبر حوارات متنوعة جمعتني مع ياسر وصديقه القاضي فيصل محمد علي مسلّم (1943- 2018)، على مدى نحو عقدين من الزمان. كانت الحوارات تقوم على التداول بشأن قضايا الثقافة والفكر، والتبادل للمنتجات الفكرية، فضلاً عن المتابعة لشؤون الثورة السودانية. للأسف انتقل القاضي فيصل إلى الرفيق الأعلى في 9 نوفمبر 2018، قبل ان يشهد اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة 19 ديسمبر 2018، والتي كان ينتظرها. ظل تواصلي مع ياسر مستمراً، ولا يزال، وبقي الإتقان من أهم سمات الأداء عنده. كذلك يتميز ياسر بأنه يعمل بالقلب والعقل، لتأتي المحبة عنواناً لعمله. ويقيني أن أول ما يطالع القراء والقارئات في هذا الكتاب، هو دقة ياسر وإتقانه ومحبته لسليم، ولكل ضحايا العبودية. ونلمس ذلك في جوانب مختلفة، سواء في الرسومات والنحت لتماثيل سليم، أو في الإهداء. لقد أهدى ياسر عمله في ترجمة سيرة سليم، قائلاً:
نـُـهدِى سيرتهُ إلى ضحايا العبوديَّة:
أولئك الذين وُلِدُوا ليترَعْرَعُوا في الخَفاء
وليبدِّدُوا عَبَقَ صِباهم في هجيرِ الصحراء
هام ياسر مع سليم وتفاصيل حياته الملهمة على مدى عقدين من الزمان، بكل محبة واحترام وفخر. لمست هذا من متابعتي، كما تفيدنا بذلك أعماله الفنية الإبداعية المصاحبة للترجمة. لقد قام ياسر برسم تخيّـلي لوجه سليم أغا التقلاوي وهو في عُمر العاشرة “بورتريه سليم، وهو الذي على غلاف الكتاب”، فأُعجب ماكارثي بالرّسم ووصفه بالرائع، ونشره في موقع صحيفة جمعية هاكلويت Hakluyt Society Journal. ثم طلب من ياسر الموافقة له باستخدامه في كل اضافاته للكتاب، حتى يُضفى ذلك، كما قال ماكارثي، نوع من المصداقية إذا كان الرسّام، وهو ياسر، ينتمي إلى مكانٍ ما بالقرب من موطن سليم أغا، وهو السودان. ولما رأى الدكتور كواسي كونادو kowasi konadu بورتريه سليم، وكان يعد في كتاب يتصل بالموضوع، طلب من ياسر الموافقة على استخدام صورة سليم في كتابه، فوافق ياسر. صدر كتاب كونادو بعنوان: Transatlantic Africa (1440- 1888) ضمن سلسلة African World Histories عن دار جامعة أكسفورد للنشر Oxford University Pressمتضمناً بورتريه سليم.
بقي ياسر في تمعن وتأمل في حياة سليم الملهمة، فقام بإعمال الخيال التاريخي، فنحت تمثالاً من مادة معجون الزجاج لشخص سليم التقلاوي يصوّره ككشـّاف في مقدّمة الصفوف. وكانت هذه أول تجربة له في النحت، مما يفيد بأن حياة سليم الملهمة فجرت الابداع في داخله، خاصة وأن ياسر أتبع ذلك التمثال بتماثيل أخرى كلها مضمنة في هذا الكتاب. أرسل ياسر صورة التمثال الأول إلى ماكارثي وإلى حفيدة سليم أغا التقلاوي، ماريون وولز. فكتبت وولز إلى ياسر، قائلة: “هذا التمثال الذي يُجسّد سليم أغا هو جميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هل صنعته بنفسك؟ لقد جلب لعينيَّ الدموع وقليل من الحزن ولكن أيضاً أشعرني بالفخر. أنا فخورة للغاية بسليم لقد كان رجل ذو شخصية رائعة وهذا التمثال يبعثه للحياة من جديد”. ثم طلبت وولز من ياسر أن تحصل على نسخة من التمثال.
كذلك لم يتوقف ماكارثي عن البحث في حياة سليم أغا، فبعد نشره لكتابه عام 2006، حصل على معلومات إضافية، زود بها ياسر، والذي قام بدوره بإضافتها للنسخة العربية. كذلك استطاع ماكارثي أثناء انشغاله بعمليّة البحث عن حياة سليم أغا، أن يكتشف أقارب مباشرين لسليم يعيشون في إسكتلندا والولايات المتّحدة. كما تواصل مع ماريون وولز المُقيمة في كيركينتِلّوش Kirkintilloch، وهي الحفيدة من الدرجة الثالثة لسليم. كما تواصل مع لاين آدامز Lynn Adamsمن كَمبرنولد Cumbernauld بالقرب من جلاسجو، والذي كانت جدّته ابنة (أليكزاندر هَنتر أغا)، الذي هو ابن سليم. كما التقى بدون كريفي – Don Crevie من سياتل أثناء زيارته لإسكتلندا عام 2004، وهو حفيد سليم من الدرجة الثانية، إلى جانب آخرين ورد ذكرهم في الكتاب. غير أن الملفت للنظر أمران: الأول وهو يتصل بأنه لم يرد ما يفيد بمحاولة سليم الاتصال بأسرته في تقلي. وقد أشار لهذه الملاحظة المؤلف ماكارثي، حيث كتب، قائلاً: “ليس هناك دليل يُشير إلى محاولات سليم التواصل مع أُسرته الأصليّة”. والأمر الثاني هو أنني لاحظت بأنه لم يظهر في الكتاب اسم أي من أقرباء سليم من السودان، كما هو الحال من بلدان أخرى. بالطبع ربما يعود السبب إلى أن سليم غادر تقلي صغيراً، وهو ابن التاسعة. وقد يرجع السبب إلى أن ملف سليم لم يفتح في السودان، وربما يحدث ذلك في مقبل الأيام، بعد أن قام ياسر بتوطين مذكرات سليم وسودنة تاريخ حياته ووجدانه وتصوراته.
يكشف الكتاب بأن هناك صداقة جمعت بين ياسر وسليم من جهة، وبين ماكارثي وسليم، من جهة أخرى، وبين ياسر وماكارثي، من جهة ثالثة، وكان محورها مذكرات سليم وحياته الملهمة. ومن الواضح أن الكتاب وترجمته، من الأعمال التي تمت بمحبة صادقة، غير أنها لم تلغ روح النقد. وهنا نستحضر المؤرخ الفرنسي هنري مارو Henri I. Marrou (1904-1977)، الذي كتب في كتابه: the Meaning of History، قائلاً: “لابد أن تجمع بين المؤرخ وموضوعه صداقة، وإلا فكيف للمؤرخ أن يفهم؟ فحسب عبارة القديس أوغسطين (354م- 430م) الرائعة: (لا يمكننا معرفة أي أحد إلا عبر الصداقة). إن تصوراً من هذا النوع بالتأكيد لا يلغي روح النقد”. وأضاف مارو، قائلاً: “فالروح النقدية والتعاطف ليسا متناقضين بالضرورة، ولكن لا نستطيع القول بأنه يمكننا دائماً التوفيق أو الجمع بين هاتين الفضيلتين، أو تساويهما في ذهن كل باحث/ دارس. بيد أن توصيف التاريخ هو ثمرة لجهد جماعي، فإفراط البعض يُقوِّم تقصير البعض الآخر” .
الحر هو من يعمل
الفهم الجديد للإسلام وإعادة التعريف لمفهومي العبد والحر
ظل سليم منذ مغادرته إسكتلندا التي عاش فيها أثنى عشر عاماً، ووصوله لندن في العام 1849 وإقامته فيها، وهو وحيد، لأول مرة منذ ان تجرع مرارة العبودية. ظل يعمل بلا توقف. كان مشغولاً بالحرية والتحرير من الرق، ومسكوناً بتنمية أفريقيا، وتحرير الأفارقة. كان هدفه الواضح من قدومه إلى لندن، كما عبر المؤلف ماكارثي، هو تنمية علاقات تجارية بين بريطانيا و(بَلده). كذلك قام سليم بالإسهام في تأسيس جمعية تحسين حياة سكان أفريقيا African Amelioration Society، وأصبح المسؤول عن استلام التبرعات والاشتراكات. وبالإضافة لكتابة الشعر، قدم العديد من المحاضرات في قاعة بيكاديلي المصرية عن بانوراما النيل، وعن تجربة العبودية. وقام سليم برحلات واسعة في أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية وعاد إلى أفريقيا. شارك في رحلات استكشافية إلى نهر النيجر عام 1857، ورحلة استكشافية إلى نهر النيل، ورحلة استكشافية إلى نهر الكنغو عام 1863، ونهر النيجر عام 1857. وقام برحلات استكشافية إلى أعماق أفريقيا، وقضى سنوات في ليبيريا حيث توفي عام 1875. كما قدم سليم إلى وزارة الخارجية البريطانية خطة مكتوبة لمشروع تنموي في أفريقيا، وظل يسعى لتنفيذها، دون جدوى. تمثلت الخطة في “بناء خط سكك حديدية من الشرق إلى الغرب عبر حزام وسط أفريقيا، يمتد من (زيلع) في البحر الأحمر إلي (كالابار) القديمة في الساحل الغربي لأفريقيا”.
وصف سليم خطته، قائلاً: “إن مَدّ خطوط سكك حديدية عبر القارة الأفريقية… سيؤمّن التجارة مع الصين، وشرق الارخبيل الهندي، والهند، وسيلان، والجزيرة العربية. وسيختصر الرّحلة التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح ويبلغ طولها سبعة آلاف ميل”. وأضاف، قائلاً: “يمكنك أن تتخيّل بنفسك المشهد المُفرح وأنت ترى مواطني (جالا) والحبشة ودارفور و(بورنو) والهوسا وبلدان (إبوا) وهم يتجمّعون في محطات القطارات الخاصة بهم ليبادلوا منتجات أفريقيا الطبيعية”.ظل سليم مستكشفاً في أفريقيا “حتى وفاته كما يُعتقد في ليبيريا عام 1875م”.
لا جدال في أن سليم أغا ومنذ أن نال حريته، عاش حياة جادة وعامرة بالعمل والعطاء والإنتاج. فهو الشاعر، والمحاضر، والمستكشف، وصاحب المبادرات في التنمية والتحرير. ثم مرشحاً لرئاسة ليبيريا. الأمر الذي يجعلنا نقف أمام نموذج للإنسان الحر بحق، كون “الحر هو من يعمل”، وفقاً للفهم الجديد للإسلام، الذي طرحه المفكر السوداني محمود محمد طه (1909- 1985). وبالطبع ليس وفقاً للفهم القديم للإسلام، وهو فهم متخلف، وليس وفقاً لقانون الغابة الذي عاشته الإنسانية، حيث الرق الذي هو ثمرة لغلبة الأقوياء على الضعاف، ولا يزال واقعاً معاشاً ومستمراً بصورة من الصور. إن الفهم المتخلف للإسلام، وقانون الغابة، أودعا سليم سجن العبودية وجرعاه عذاباتها. وظل الفهم المتخلف للإسلام، وهو السائد في الفضاء الإسلامي منذ قبل تاريخ استرقاق سليم وحتى اليوم، ينطوي على العبودية واللا مساواة والعنصرية، في أبشع صورها. وقد تأذينا نحن في السودان كثيراً، ولا نزال، من الفهم المتخلف للإسلام، فهو المرجعية للأحزاب السودانية التي ظلت تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو الذي أدى لحل الحزب الشيوعي السوداني عام 1965. وهو الذي برر التآمر من أجل انعقاد محاكمة المفكر محمود محمد طه بالردة عن الإسلام في 18 نوفمبر 1968 “عار القضاء السودان”، وتنفيذ حكم الإعدام عليه في 18 يناير 1985. كذلك كان الفهم المتخلف للإسلام سبباً في سجن وقطع أطراف الكثير من البسطاء، من الرجال والنساء، أمام قوانين سبتمبر 1983، ما سمي بالشريعة الإسلامية. وهو الذي كان من وراء سياسات دولة ما بعد الاستعمار، التي ساقت لفصل جنوب السودان عام 2011، وهو الذي كان سبباً في اندلاع الحرب الدائرة اليوم في السودان، ولا يزال من أهم مغذياتها.
وإذا ما تصورنا أن سليماً كان عايش اليوم في مسقط رأسه في تقلي بجبال النوبة، لوجد نفسه أمام الفهم المتخلف للإسلام، حيث الشريعة الإسلامية التي لم تغب عن سماء بلاده السودان، ولأصبح مواطناً من الدرجة الثانية، كما تنص الشريعة الإسلامية الحاضرة. وعندها سيكون سليم، الذي ظهرت عبقريته، وتتبعنا تميزه، أمام أحد خيارين، إما القبول بأن يكون مواطناً من الدرجة الثانية في وطنه، وهو من الشعوب الأصيلة، أو أن يختار الكفاح المسلح من أجل التغيير والتحرير، كما هو حال أبناء منطقته بجبال النوبة في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة القائد عبد العزيز الحلو. ومهما كانت الخيارات، فلا مجال للحرية والسلام والتعايش والعدالة، في ظل الفهم السائد للإسلام، حيث الدعوة للشريعة الإسلامية، والدستور الإسلامي.
ويقيني بأنه ليس هناك عاصم سوى الفهم الجديد للإسلام الذي طرحه محمود محمد طه. فهو الفهم الذي يتيح الفرصة لتحقيق الوحدة والحرية والسلام مع المساواة التامة بين جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، بغض النظر عن دياناتهم وألوانهم وأعراقهم وألسنتهم. ويمكن لأي منهم، ممن ذوي العقل والأخلاق، رجلاً كان أم امرأة، له دين أو بلا دين، أن يكون رئيساً للسودان. وهذا ما عبر عنه الدكتور فرانسيس دينق، قبل أكثر من ثلاثة عقود، قائلاً: “إذا ما قُدر لمحمود محمد طه أن ينجح في تحقيق نظرته للمسيرة الإسلامية مرشداً للحركة السياسية في البلاد، لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين، وشجع احترام الأسس الديمقراطية على خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء”. وأضاف، دينق متناولاً الخسائر جراء كبت فكر طه، فكتب، قائلاً: “أدى كبت فكر محمود محمد طه، إلى ضياع الفرصة لتطوير هوية وطنية أكثر شمولاً وتكاملاً. على كلٍ، ساعد كبته في الحفاظ على هوية الجنوب كوحدة مختلفة ثقافياً ودينياً .
قدم محمود محمد طه، انطلاقاً من الفهم الجديد للإسلام، تعريفاً جديداً لمفهومي الحر والعبد، ومعياراً إسلامياً إنسانياً جديداً للمفاضلة بين الناس. فهو يرى بأن “الفرد الحر هو الذي يعمل، يعمل ما يريد ويتحمل مسؤولية عمله”، بينما “العبد هو الذي يترك حرية عمل ما يريد خوف المسئولية التي تترتب على الخطأ”. ويأتي بينهما الفرد الفوضوي، وهو “الذي يحب أن يعمل ما يريد، ولكنه عند الخطأ يحاول جاهداً أن يخدع القانون ويتهرب من تحمل مسؤولية عمله” . وتتضح تلك التعريفات عند محمود محمد طه، عندما تحدث عن دور الديمقراطية (المساواة السياسية) في إنجاب الأحرار، فقد كتب، قائلاً: “إن الديمقراطية هي وسيلة لإنجاب الأحرار من العبيد، والفوضويين، وهي صنو الاشتراكية، ولا خير في أيهما من غير الأخرى. فإن الاشتراكية إذا طبقت تحت حكم دكتاتوري لا تربى غير العبيد، وإذا ما حاولنا تطبيق الديمقراطية تحت نظام اقتصادي متخلف، وهو النظام الرأسمالي في أي صورة شئت، فإنها تكون قبض الريح، ومجرد لعب على العقول” . إن ما اتي به محمود محمد طه من مفاهيم إنسانية وقيم أخلاقية من داخل الإسلام، يجعلنا في أمس الحاجة لفتح الحوار حول فكره، واستخراج الحلول لمشاكلنا من داخل ذلك الفكر.
المفاضلة بين الناس وفقاً للفهم الجديد للإسلام
المفاضلة بين الناس تكون بالعقل والأخلاق وليس بالدين أو العنصر أو اللون أو الجنس
تسوقنا تجربة سليم أغا في سجن العبودية، وسماء الفهم القديم للإسلام، ومن ثم تقديمه لنموذج الإنسان الحر، صاحب العقل والأخلاق، إلى موقعه المتقدم في سماء الفهم الجديد للإسلام، وأسس الدستور الإنساني. يدعو محمود محمد طه إلى الدستور الإنساني. وهو الدستور الذي يسوق إلى الحكومة الإنسانية، انطلاقاً من تطوير الشريعة الإسلامية من داخل القرآن، حيث آيات الأصول (الآيات المكية)، آيات الحرية والكرامة والاسماح. وهو دستور يكفل الحقوق الأساسية للجميع، حق الحياة، وحق الحرية، وما يتفرع منهما، ولا يوجد حجر على حرية المواطنين وعلى حرية الفكر والعقيدة. وفي هذا المستوى، كما يقول طه: المفاضلة بين الناس تكون بالعقل، والأخلاق، وليس بالدين أو العنصر أو اللون أو الجنس . وفي الدستور الإنساني، الذي يسعى لإقامة الحكومة الإنسانية، “لا يسأل الإنسان عن عقيدته، وإنما يسأل عن صفاء الفكر، وإحسان العمل” .
ومن هنا، كما يقول محمود محمد طه لا يقع تمييز ضد مواطن بسبب دينه ولا بسبب عدم دينه ، وبهذا تنتقل الفضيلة، كما يرى، من قوة العضل، إلى قوة العقل، وقوة الأخلاق، ولن يكون حظ المرأة، في هذا الميدان، حظا منقوصاً، وإنما هي فيه مؤهلـة لتبز كثيراً من الرجال. وينتفي بذلك الاستضعاف والتهميش والإقصاء والابعاد، فلكل مواطن الحق في أن يعتنق ما يشاء من الأفكار والأديان .
وكل مواطن يحمل أفكاراً مهما كان دينه أو مذهبه، أو كان بلا دين، أو ملحداً، أو لا أدري، أو غير مقتنع بالإسلام، فإن له الحق في أن يدعو إلى أفكاره بالوسائل الديمقراطية. فالملحد “يطرح أفكاره وإلحاده لمصلحته ولمصلحة المجتمع ويواجه الآخرين” في وسائل الإعلام ومنابر الحوار . كذلك المواطن غير المقتنع بالإسلام ولديه فكر، فمن حقه أن يدعو بالوسائل الديمقراطية للفكر الذي يعتنقه، وعلى من لديهم معرفة بالإسلام أن يواجهونه بالفكر والحجة ويردونه عن أفكاره .
والإسلام في هذا المستوى، كما يقول محمود محمد طه: “يعيش في مجتمعه جميع المواطنين على احترام وتساو بينهم (بحق المواطنية لهم كل الحقوق) ولا يميز ضد أحد باعتبارات الملة”. كذلك في متطلبات وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مثلاً، يجب ألا يكون هناك شرطاً من بين الشروط يقول: “إن رئيس الجمهورية لازم يكون مسلم”، وإنما يجب وضع القامة المطلوبة في الكمالات الإنسانية التي يراها الناس من أجل الترشح للمنصب. ثم أي إنسان تنطبق عليه هذه الكمالات الإنسانية يمكن أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. وليس شرطاً أن يكون المرشح مسلماً أو مسيحياً، أو يدين بأي ديانة، أو لا ديني أو لا أدري .
واجه محمود محمد طه مؤامرات خبيثة قادها تحالف ديني عريض، أدت إلى الحكم عليه بالردة عن الإسلام مرتين، ثم تنفيذ حكم الإعدام عليه في العاصمة السودانية الخرطوم في 18 يناير 1985. ثم ما لبثت المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في السودان، أن أعلنت في 18 نوفمبر 1986 بطلان الحُكم الصادر في حق محمود محمد طه وتلاميذه. ووصفت الحكم بأنه لم يكن سوى كيدٍ سياسيٍ . واليوم، ومع كل صباح جديد، يشهد الفضاء الإسلامي حراكاً واسعاً حول فكر محمود محمد طه، وقد لخص الأمر المفكر التونسي الدكتور يوسف الصديق، قائلاً: “محمود محمد طه هو المنقذ” .
قبل الختام، ونحن نحتفي وبكل فخر بهذه السيرة المشرقة والمشرفة سودانياً وإنسانياً، لصاحبها الإنسان الحر، وبحق، سليم أغا التقلاوي، يليق بنا وبها أن نجعل منها فرصة للتنادي من أجل البناء الجماعي للوطن، وأنسنة الحياة. ذلك عبر فتح الملفات المؤجلة: ملف الذاكرة الاستعمارية، وملف إرث العبودية والعنصرية، وملف المظالم المتراكمة، وملف حاجتنا للوحدة والحرية والسلام والعدالة، شعار ثورة ديسمبر المجيدة، ليس عبر المغالطات الراهنة، وإنما عبر المواجهة الشجاعة للتاريخ والراهن بالعلم والفكر واعمال الخيال التاريخي. ولننتقل بمعنى التاريخ عبر سيرة سليم، من كونه دراسة للماضي، إلى أنه أداة من أدوات إحداث التغيير والاستشراف للمستقبل. إننا إذا ما نظرنا للتاريخ برؤية المفكر محمود محمد طه مقرونة بواقع اليوم، فإننا ندرك بأنه ومنذ أن سُرق منا سليم لم نتقدم تقدماً يذكر. كون التاريخ الحقيقي للمجتمع والشعوب عند محمود محمد طه، يكون مرصوداً في التشريعات والقوانين. ويرى طه بأن التاريخ إذا دُرِس عبر تطور القوانين، القوانين الدينية وغير الدينية، وانتقالها من بلد لبلد، يُمكِن من معرفة التاريخ الحقيقي للمجتمع والشعوب. كما أن تقدم التشريعات يمثل دليلاً على تطور المجتمع، ويمكن أن تكون التشريعات من أدق آليات تقييم مدى تطور المجتمع . فهل تطور المجتمع السوداني في دستوره وتشريعاته، بما يخدم الوحدة والحرية والسلام والعدالة، منذ أن غاب عنا سليم وحتى عودته إلينا اليوم؟ وهل انتقلت الفضيلة عبر التشريعات، من قوة العضل، إلى قوة العقل وقوة الأخلاق، كما ورد آنفاً، حتى تُلغى حقوق الامتيازات التاريخية من أصحاب الامتياز، وينتفي الاستضعاف والتهميش والإقصاء والابعاد؟ حقاً نحن في حاجة إلى سيرة سليم، لتسعنا في قراءة التاريخ قراءة متبصرة، ولنتفحص الراهن بعلم وفكر، حتى ندخل المستقبل بأسس سودانية جديدة وبهُوية إنسانية عابرة لكل الهُويات ومشتملة عليها.
ختاماً أتقدم لصديقي الباحث والفنان ياسر عَـبِـيدِى بَرْدَويل بخالص الشكر وفائق التقدير، على تشريفه لي بطلبه مني كتابة هذا التقديم، فلقد تعلمت واستمتعت، وأسرفت. لهذا أعتذر للقارئات والقراء الكرام عن هذا الإسراف. غير أنه إسراف جاء عن وبمحبة لسليم ولياسر وللسودان وللإنسان حيث ما كان. كما أنني وددت التعبير عن احترامي واحتفائي وافتخاري بالشاعر والمستكشف والمعلم سليم أغا التقلاوي، وبكل الذين تجرعوا مرارة العبودية، فهم كانوا فداء لنا. ويقيني أن القارئات والقراء الكرام سيجدوا في هذا الكتاب، معرفة ومتعة ومحبة، فضلاً عن طرف من إنسانيتهم، الأمر الذي يشفع لإسرافي في تقديم هذا الكتابة.