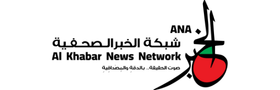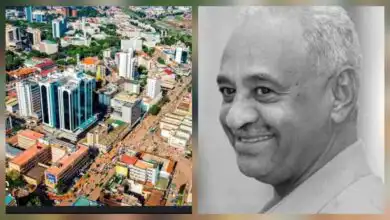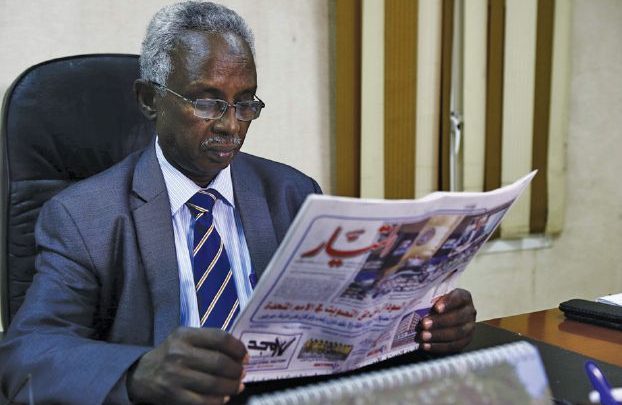عبدالله علي إبراهيم يكتب : اعتزلت المدرسة ثقافة المحيط فساءت سبيلاً

تصدر عن قريب من دار المصورات الطبعة الثانية من “كتابي الثقافة والديمقراطية” (1996). وانشغل الناس في طبعته الأولى بالفصل الموسوم “الأفروعروبية أو تحالف الهاربين” وتلك التي جادلت الدكتور ين بلدو وعشاري في القضايا التي أثارها كتابهما “مذبحة الضعين”.
ولم تجد فصوله عن التنوع الثقافي والعنف بالانقلاب أو في جامعة الخرطوم والتعليم والتراث الاهتمام الذي أتطلع لتجده هذه المرة. وأعرض هنا لجزء من الفصل الموسوم “نحو حساسية فولكلورية لتوظيف الحكاية الشعبية في التعليم” الذي نعى اعتزال المدرسة، كما رتبت لها بخت الرضا، ثقافة المحيط من حولها. وهو اعتزال بمثابة الرأي فيها من أنها لغو متخلفين عن العصر.

وفرصة مهدرة – في البدء كان التاريخ:
كنت أدور أجمع نصوص التراث في القرى السودانية ثم أعرج على المدرسة الابتدائية في القرية المعنية لبعض الأنس مع المدرسين. وقد استقر عندي أن ثمة انفصالاً مقيماً بين تلك النصوص التي تطرق أذني من نوافذ المدرسة وفي دفتر المناهج. فالطفل يسمع في بيئاته نصوصاً تراثية ذات قيمة ذوقية عالية. فإذا جاء إلى المدرسة افترضت المنهج المدرسي أنه لوح مسموح خال من كل معرفة. وتسابق المدرسون يحقنونه بالمعرفة.
المدرسة الابتدائية السودانية كما جاء عند السيد قريفث، الذي صمم ذهنها ومناهجها في الثلاثينيات من هذا القرن، انبنت على أنها مؤسسة غنية لمجتمع فقير، فقريفت يقول: إنه بخلطة التلاميذ السودانيين اتضح له أن خلفيتهم الثقافية البيئية محدودة. وتابع كتاب (مرشد معلم التاريخ للمدرسة الأولية) هذا التبخيس لإمكانيات الطفل الداخل للمدرسة الابتدائية فهو يقول: “التاريخ سجل لأحداث بعيدة عن التلميذ في أغلب الأحيان. بعيدة عنه في الزمان كما هي بعيدة عنه في المكان. وهي غلباً ما تتعلق بآراء ومقاييس نادرًا ما يستطيع فهمها وتقديرها”.
وبناءً على هذه الملحوظة التربوية فالتلميذ لا يُعطَى دروس التاريخ إلا في السنة الثانية أو الثالثة الابتدائية. ويصح هنا أن نسأل: هل صحيح أن التاريخ بعيد عن التلميذ كما يزعم المرشد؟
وأجيب بالنفي. فالتلميذ يأتي إلى المدرسة بحكايات كثيرة عن التاريخ. فلربما جاء التلميذ بقصص (تجارب شخصية) منقولة عن جده الذي اشترك في حروب المهدية، أو عن والده الذي اشترك في بناء خط السكة الحديد، أو جدته التي زارت ضريح وليٍّ في طرف من أطراف البلاد لأسرتها عقيدة في كراماته وبركته. وغالباً ما يأتي التلاميذ إلى المدرسة بعد أن تشبعوا بزيارات متكررة لمواقع أثرية أو تاريخية في ظهر قريتهم أو سمعوا (حكايات شارحة) لتلك المواقع، فالتاريخ الذي يحمله أطفال قرية مسكفيشو (التي هي في بلاد النوبة السودانية) إلى المدرسة كفيل بلفت نظرنا إلى الكم الهائل من الحكايات التي نهدرها والتي كان يمكن أن نوظفها في التدرج بأولئك الأطفال في التعرف على التاريخ من واقع تجاربهم الباكرة معه.
في عيد الفطر بوجه خاص يستأجر الأولاد في قرية مسكفيشو مركباً شراعياً ويتنزهون بها في النيل ويذهبون بها للبر الشرقي حيث جبل الصحابة. ففي الجبل ضريح سيدنا أمير عمر ويقال: إن أمير هذا هو أحد الصحابة (صحابة الرسول ص) دفن هنا في النوبة، وأقيم عليه ضريح ومزار. ويصعد الأطفال الجبل وفيه بئر قديمة قيل إن الجن هو الذي حفرها في قديم الزمان بالإبر. وبالجبل آثار منازل سكنية قديمة.
أما أولاد الضاحية الشمالية من مسكفيشو فهم يذهبون إلى سلسلة الجبال والتلال على الأرض الممتدة المترامية خلف الجبال. فيجدون هناك بقايا حيوانات وخيول (عظام إبل وخيول، أوتاد، قطع من الحبال، حدوات . . . إلخ). ويجد الأطفال شظايا قنابل ومتفجرات. وهذه آثار موقعة أرقين بين جنود المهدية والإنجليز التي جرت في 1889.
أما أولاد المنطقة الوسطى فيذهبون إلى الفلاة ثم إلى حجر أحمر منبسط مساحته 50 مترًا مربعاً وفيه نقوش تاريخية. وفي تلك المساحة الصخرية توجد 8 حفر قدت على نسق واحد. وتأتي إلى هذه الحفر كل الطيور لتشرب من الماء الذي تختزنه فيصطادها الأولاد ويشيع في المكان جو مهيب من السحر والتاريخ.
هل هذه بيئة محدودة كما يقول قريفث؟ هل التاريخ بعيد جداً عن هؤلاء التلاميذ كما يقول مرشد التاريخ؟ يأتي هؤلاء الأطفال إلى المدرسة بذخيرة من التاريخ أهم ما فيها الدليل التاريخي الذي يتمثل في الآتي:
( أ ) أسطورة المنشأ أو الأسورة الشارحة.
(ب) بقايا العظام.
(ج) الرواية الشفاهية.
المربون هم الذين يظنون التاريخ حالة من التدرج من الأسفل إلى الأعلى، من القديم إلى الجديد، وهو حالة علوية لا علاقة لها بالبشر والأطفال خاصة. ولذا يبدأ التاريخ في الصف الثاني الابتدائي بكتاب اسمه (نحن وأجدادنا) ويبدأ درسه الأول بالعصر الحجري. فتصور!
لقد كان ممكناً لمدرس التاريخ (لو لم يصادر المرشد حسه بالمعطيات التربوية حوله) أن يبدا بالعصر الحجري لو كان في القرية حوله موضع يغشاه التلاميذ ونسبته إلى العصر الحجري مؤكدة. وبغير ذلك يمكن أن يبدأ التاريخ في كل مدرسة بالمعطيات التاريخية الحقيقية التي يأتي بها التلاميذ إلى حظيرة المدرسة. وستلعب الحكايات في التعليم المرن للتاريخ دورًا كبيرًا. غير أن التربويين يتمسكون بمركزية المنهج والتوجيه ويرتكبون بذلك حماقة كبيرة لأنهم يفرغون تلاميذهم من رصيدهم التاريخي الملموس ليستبدلوا لهم ذلك بتاريخ مجرد اعتباطي.