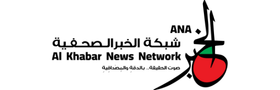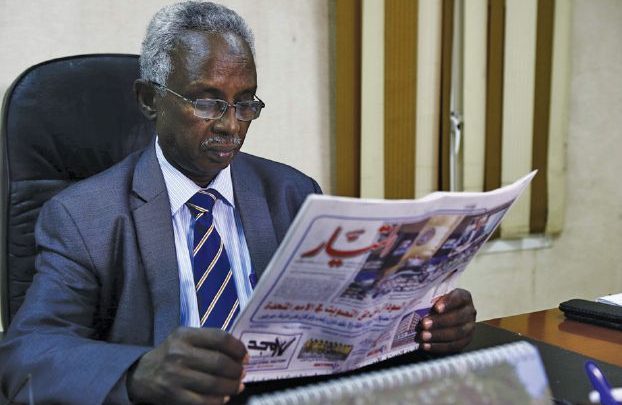عبدالله عابدين يكتب : زغرودة الكنداكة: علامة فارقة في طريق النضال الثوري السوداني

مثّلت “زغرودة الكنداكة” شارة لضبط الوقت الثوري في ثورة ديسمبر المجيدة، كما أشرتُ إلى ذلك في مقال سابق بهذا العنوان. ومن نافلة القول إن زغرودة المرأة السودانية أضحت ليس فقط شارة لضبط الوقت، بل مصدراً ثراً للحماس الثوري، نبعت منه ينابيع الرفض والاحتجاج ضد كل ظلم واضطهاد عبر تاريخ السودان المديد.

ويبدو أن هذه المظاهر —من قبيل الزغرودة، وغناء “الحكامات” وشعرهن— قديمة في التراث السوداني، من حيث الدور الرائد الذي مثلته في صد الأخطار عن الوطن أو عن المجموعات الإثنية، وفي إشعال الحماس والحض على البسالة والإقدام في قلوب السودانيين؛ بحيث أنهم “إذا ما دعا داعي الفداء لم يخونوا”. بل إن الأمر فيما يختص بدور المرأة السودانية النضالي يتجاوز مجرد الحماسة إلى قيادة الجيوش، كما هو الحال مع “كنداكات كوش”. أما في تاريخنا الحديث، فإن نموذج المحاربة “مندي بنت السلطان عجبنا” يقف صارخاً يلفت الأنظار ويجذب الانتباه.
إذن، فإن تقليد زغرودة الكنداكة في ثورة ديسمبر ورمزيتها يأتي من مكان قصي في العقل الجمعي السوداني منذ فجر التاريخ، وعبر مراحل تشكل “أرض الأصل والمنشأ” السودان، إلى أن انبرت ثورة ديسمبر باستعادة هذا التقليد العريق وبعثه حياً ينطق عن أصالة الأرض وشعوبها عريقة الأصل.
ومما جعل مساهمات النساء في ثورة ديسمبر بهذا الزخم الكبير، أن المرأة السودانية نالت نصيب الأسد من شتى صنوف الاضطهاد والقهر من قبل نظام “الإنقاذ”، حتى لكأن هذا النظام قد بدا وكأنه مصاب بـ “لوثة” ضد المرأة. بل إن عداوته الصارخة لها تشي بوجود “عقدة نفسية” جماعية؛ وإلا فلماذا تُجلد المرأة هكذا في العلن، وهي تصرخ وتتلوى من الألم مستجدية إياهم التوقف عن ضربها، بينما طائفة منهم —بما فيهم قاضي المحكمة نفسه— يشاهدون ذلك؟! هل يتلذذون بذلك؟! والأدهى والأمر أن رئيس الجمهورية، حينما وُجّه له سؤال عن هذا الأمر الحساس في لقاء تلفزيوني، أجاب بأنه لا يتوانى في “تطبيق شرع الله”، ولا “يخاف في الله لومة لائم”، أو شيئاً بهذا المعنى.
يا لها إذن من سادية فاقت حدود الاضطراب النفسي، وتجاوزت تخومه المعروفة، وانحدرت إلى درك سحيق من الانحطاط النفسي والخلقي، تتأذى من وقعه الفطر السليمة. فلماذا لا يتأنى هؤلاء متفكرين في هول ما يقترفون؟ أم على قلوب أقفالها؟!
وفي هذا السياق الموغل في السادية، يأتي تعرضهم للحركة النسوية السودانية بشتى أشكال وصنوف القمع، وكأن خيالاً مريضاً يصور لهم بأن المرأة هي مصدر كل شر في الوجود. بل إنهم، من فرط هذه اللوثة المرضية، غارقون في هذا التبسيط المخل لـ “مشكلة الشر” التي أعيت الفلاسفة والمفكرين عبر العصور. وهنا أميل إلى الظن بأن هذا القبيل من “المتأسلمين” لا يخلو من سِمات الضحية، بينما هم في ذات الآن واليغون في دور الجلاد!
هذه السردية الماثلة عند منعرج حكم الإنقاذ لبلادنا لا ضريب لها في تاريخنا السياسي الحديث؛ حيث شكل الإسلام السياسي تحدياً غير مسبوق لشعوب السودان، ووقف عائقاً أمام حركة التطور الاجتماعي العامة، وتطور حركة المرأة السودانية خاصة. إنني لا أقول بأن هذا هو العائق الوحيد، وإلا أكون قد تورطت في تبسيط مخل أنا الآخر، ولكني أؤكد على عمق أثر هذا العامل، كونه تمادى في إخفاء خطره العظيم بالتلحف بقداسة الدين الحنيف.
وعلى الرغم من هذه الظروف القاهرة، دأبت عدة منظمات واتحادات ومراكز مناصرة لحقوق المرأة على قيادة حملات جريئة للتصدي للقضايا الملحة. ونذكر هنا بعضاً من هذه الكيانات المناضلة: مجموعة “لا لقمع المرأة”، و”المنظمة السودانية للبحث والتنمية”، و”مركز سيما لحماية حقوق المرأة والطفل”.
منذ توليها مقاليد السلطة، وضعت “الجبهة الإسلامية القومية” العديد من القوانين التي تميز ضد المرأة للحد من مشاركتها في الشأن العام وحصر دورها في المجال الخاص، والتحكم في حياتها وجسدها. وقد تحملت المرأة نصيب الأسد مما عرف بـ “قانون النظام العام”. وفي هذا السياق، اعتمدت الكثير من المؤسسات التعليمية والحكومية أنظمة داخلية تلزم المرأة بقواعد لباس صارمة.
لقد بدأ “النظام العام” كنظام محلي في ولاية الخرطوم عام 1996، وتم توسعة نطاقه ليشمل ولايات أخرى، حيث يُعاقب من ينتهكه بموجب قانون العقوبات. ويشكل هذا القانون تهديداً حقيقياً لكرامة المرأة؛ ففي كل عام كان يتم اعتقال ما يربو على 4 آلاف امرأة بتهمة انتهاكه، ويُحكم عليهن بعقوبات مبرحة ومذلة تشمل الجلد والحبس والغرامة.
ومن بين أبرز القضايا، قضية الصحفية “لبنى أحمد الحسين” التي اعتُقلت عام 2009 بتهمة “ارتداء زي فاضح” وفقاً للمادة 152. وفي أعقاب قضيتها، أسست مجموعة من الناشطات مبادرة “لا لقمع المرأة” بهدف إلغاء القوانين التمييزية وتحقيق المساواة.
كان هجوم الدولة على المجتمع المدني صارماً، ووصل ذروته في العقود المنصرمة، حيث عانت منظمات حقوق المرأة من صعوبات في التمويل والتسجيل، ووصل الحد إلى إلغاء فعاليات يوم المرأة العالمي. وفي ظل هذا الوضع، استمرت مجموعة “لا لقمع المرأة” —التي كانت مديرتها الدكتورة إحسان فقيري معتقلة سياسية منذ 22 ديسمبر 2018— في عملها، مشكلة حالة تضامن ومناهضة لاضطهاد النساء.
استهدفت المنظمة دعم النساء المتأثرات بالقوانين الجائرة، وخاصة “بائعات الشاي” (ستات الشاي)، اللواتي يُعتقلن بسبب نشاطهن الاقتصادي. فبدلاً من دعم سعيهن للعمل الشريف لإعالة أسرهن في ظل ظروف اقتصادية قاسية، تُشن عليهن “الكشات” المتكررة وتُصادر أدوات عملهن دون مراعاة لفقرهن. إنهن يُعاملن وكأن لا كرامة لهن، خاصة إذا كانت أصولهن من هوامش البلاد، حيث يسيطر “وسواس” التمييز العنصري على عقول الجلادين.
وتعتبر الاتهامات بانتهاك النظام العام، إلى الآن، وصمة عار تجعل الكثير من النساء يفضلن السكوت ومواجهة محاكمات ظالمة دون مساعدة قانونية. وقد نجحت المبادرات النسوية في لفت الأنظار إلى هذا التمييز وتشجيع النساء على كسر حاجز الصمت.
والآن، هل تكتمل ثوراتنا بدون الكنداكات؟ بل هل ثورة ديسمبر المجيدة ذاتها —وهي ثورة وعي سمتها السلمية— يمكن أن تكون في جوهرها إلا ثورة كنداكات؟ ثورة وصفها حصيف بأنها أنثى، إذ “كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه”، كما قال الشيخ محيي الدين ابن عربي.