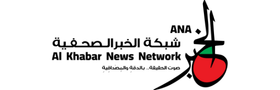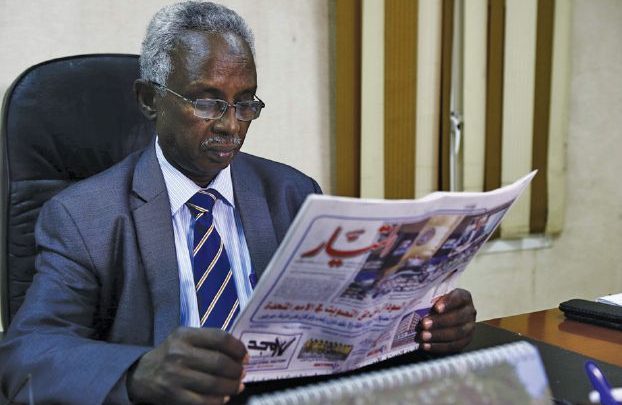جعفر عباس يكتب: مغترب مزمن أم مدمن؟

اغتربتُ مثل ملايين غيري مكرهاً ومرغماً، بعد أن اكتشفتُ عقب وصول بشارة أن طفلي الأول في الطريق، أن لا طاقة لي بنفقات رصد تطوّر الحمل، ثم رصد ميزانية إضافية توفّر الضروريات للطفل المرتقب. وكانت شركة أرامكو في الظهران محطتي الأولى، حيث فزتُ بوظيفة اختصاصي ترجمة براتب قدره 4820 ريالاً، وكان مبلغاً ضخماً في زمن كان فيه الجنيه السوداني يساوي أكثر من ستة ريالات سعودية. وعندما زودوني بتذكرة السفر، ظللتُ أبكي على مدى يومين، وتبكي معي زوجتي التي كانت وقتها عروساً ما زال بعض الملائكة يحلّقون حولها، فقد حدث ذلك بعد زواجنا بأشهر قليلة.
ذهبتُ إلى أرامكو وعملتُ مترجماً، وبعد نحو عام ونصف العام أدركتُ أنني أحب السودان أكثر من حبي للمال، فغادرتُ أرامكو وعدتُ إلى بلدي، وعملتُ مدرساً للغة الإنجليزية بمدرسة الكنيسة الأسقفية الثانوية للبنات في أم درمان. ثم وجدتُ فيزا لدخول قطر، وكسبتُ الرزق فيها من الترجمة في مجلة الدوحة وجريدة الراية، ولحساب سفارتي كوريا الجنوبية واليابان. وكانت تلك بداية الاغتراب الطويل، فاستقدمتُ زوجتي وطفلي إلى الدوحة بعزم أن نجمع مالاً يكفي لبناء بيت، ثم نعود إلى السودان.
وبعد أن أكملتُ سنة واحدة في قطر، ذهبتُ في زيارة قصيرة إلى دولة الإمارات، وهناك زرتُ زميلاً يعمل في مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، وخلال الزيارة عرضوا عليّ العمل في صحيفة Emirates News الإنجليزية محرراً/مترجماً براتب كبير، فقبلتُ على الفور لأن الراتب الكبير كان يعني أن أختصر سنوات الاغتراب بالعودة إلى الوطن فور اقتناء بيت. وكانت لي مساهمات في مجلتي ماجد وزهرة الخليج. وبعد نحو خمس سنوات هناك، قدّمتُ استقالتي وعدتُ إلى الوطن، والغريب في الأمر أنّ حتى والدتي استنكرت ذلك قائلة بلهجتها الأم: أمبا إليلن أرمود أُيقا جابجو “يا دوب الرماد كالْنا”، وكانت تعني بذلك أن من كنت أقدّم لهم العون كمغترب سيتضررون من عودتي النهائية.
وبعد أن قضيتُ شهرين في السودان راصداً الأحداث والتطورات السياسية، عدتُ إلى أبو ظبي حزيناً على نفسي وعلى وطني. ومكثتُ في مؤسسة الاتحاد أربع سنوات أخرى، ثم انتقلتُ إلى قطر بعد أن قررتُ تطليق الصحافة المكتوبة بالتسعة. قضيتُ ثماني سنوات جميلة في مؤسسة الاتصالات القطرية رئيساً لقسمي العلاقات العامة والترجمة، ثم منسقاً للإدارة العليا فيها، ثم فزتُ بوظيفة في تلفزيون بي بي سي العربي ومنه إلى قناة الجزيرة.
واليوم لم يعد الاغتراب بالنسبة لي أكل عيش وتعليم عيال، فقد أكمل جميع عيالي تعليمهم العالي بحمد الله، وهم بررة مستعدون لتقديم كل عون أحتاجه. ولكن، وحتى قبل الحرب اللعينة، كنتُ أتوجس من فكرة العودة النهائية إلى الوطن، ليس بسبب ضيق المعايش، ولكن لأنني، والعمر قد مضى معظمه، أحتاج أن أعيش في مكان تتوفر فيه خدمات طبية ذات كفاءة، في زمن اختلت فيه الساعات البيولوجية للذباب والبعوض في السودان، فلم يعد الذباب يختفي ليلاً والبعوض نهاراً كما كان الحال من قبل، بل صارا يكابسان ليل نهار لالتقاط الرزق: الذباب لا يجد ما يأكله في مكبات القمامة، والبعوض لا بد أن يعمل ورديتين لأن الدماء جفت في معظم العروق، ولا بد من لدغ العشرات للحصول على “سي سي” من الدم.
يتساءل الشاعر السوداني الراحل مصطفى سند ويجيب: متى أعود؟ ليس قبل أن تُجلل السماء بالأسى، وأن يشاهد البعير تحت إبرة الخياط! وكلما تذكرتُ بعدي عن الوطن هتفت بصوت الحوت محمود عبد العزيز: متين العودة تاني يا…
سأنشر في التعقيبات مقاطع تؤكد أن “السوّاي ما حدّاث”، رداً على من يعاتبونني لأنني لا ألطم الخدود في فيسبوك بسبب ما ينتج عن الحرب هنا وهناك، ولإثبات أنني وأفراد أسرتي معنيون بالوقوف مع ضحايا الحرب ولسنا من جماعة “بل وفْتك ومِتك وفلنقاي” إلخ.