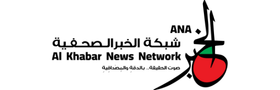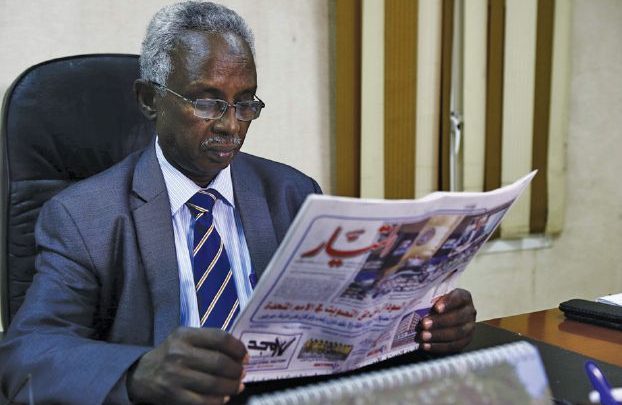فوزي بشرى يكتب: بين يدي « ..»

ما أسعدني خبرٌ في سنواتنا الأخيرة الشاحبة العجفاء مثل خبر إعادة طبع كتب جمال محمد أحمد على يد بشير أبو سن. أما جمال، فهو جمال الذي بلغ من التماهي مع اسمه مبلغًا حتى صار الاسم دالًا على صاحبه لا عرضًا عابرًا ملتصقًا به، وصار صاحبه تجسيدًا لمعناه في شيوع معنى الجمال واتساع مراميه أفقًا يمتد وراء أفق. ولستَ غير مثبت حقيقة ناصعة إن أنت قلت إن نثر جمال قد بلغ بالكتابة السودانية شأوًا بعيدًا، وأقعدها منازل عاليات في التفنن والتفرد وحسن السبك والصياغة والأفكار الجليلة يخطرن في ثياب من اللغة قشيبات فاتنات. وقد تبلغ بك جملته وفكرته، وقد برقت، تلك النشوة الطرِبة للشعر العظيم. لكنك لن تنال هذا المقام من الرضا الراضي حتى تقبل على كتابة جمال إقباله عليها، وآيته: المحبة للخلق الإبداعي، وبذل الوسع أقصاه في طلب الكمال والجمال للفكرة وللغة، ثم أخذك القراءة صنواً للكتابة تطلبًا وتحشّدًا وأنت ترقى معه مراقيها مفتتنًا، مستزيدًا. وجمال ضنين بكنوزه، لا يرميها على قارعة الطريق، يريدك شريكه إذ يكتب، وشريكه إذ يقرأ عليك، وشريكك إذ تقرأ عليه.
وكنتُ قد وقعتُ في فتنة جمال وأنا بعد في السنة الأولى من المرحلة الثانوية، وكان، بفضل ما لقيتُ من الدرس على أيدي معلمين عظام في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، قد وقع في نفسي أن ما من مكتوب بالعربية يمكن أن يستغلق عليّ. ذلك عجب السنوات النضرات. دخلتُ مكتبة المدرسة الثانوية في الدمازين وأخذتُ كتابًا بلا قصد يحمل عنوان وجدان أفريقيا لكاتبه جمال محمد أحمد. ما قرأت لجمال شيئًا ولا كنت أعرفه. أغراني الكتاب بلون غلافه الأحمر القاني وبعنوانه. قلت في نفسي: ما عساه يكون وجدانها؟
أخذتُ في القراءة فأنكرتني وأنكرتها. لا كلمة واحدة صعبة تستدعي النظر في المعجم، لكن المعاني تنحجب عنك. وهنا بدأت اللعبة الجميلة.. لعبة اللغة ورفع الطيات عن المعاني المقصورات في الخيام، ما مسّهن من قبل إنس ولا جان.
السر العظيم يا مولاي في التركيب، وفي إنشاء الكلام خلقًا آخر. السر ليس في المادة الخام، الثماني والعشرين حرفًا، ولا السر في سبيكة الذهب، بل في الذي يصنعه الكاتب بهذه الحروف الثماني والعشرين، وما يصنعه الجواهرجي بكتلة الذهب.. ذلك الخلق.. ذلك هو الإبداع.
في كتابة جمال ثمة حياة جديدة للمفردة، للكلمة، كأنها خرجت إلى الدنيا ساعتها هذه، تخطر فرحة بين يديك. لن تبلغ من جمال ما تريد حتى تحيا الكلمات عندك حياتها عنده، وهذه قراءة تقرب أن تكون أختًا للكتابة.
أما أفكار جمال والقضايا التي وقف عليها روحه وقلمه، فهي تشرق بك وتغرب مع انشغالٍ بإفريقيا لا يخفى. وقلَّ في الكتاب والمثقفين السودانيين من أقبل على إفريقيا بمحبة وفهم وحنوٍّ إقباله عليها، والحديث في هذا يطول ولا يسعه حيز الكتابة هنا.
أما بشير أبو سن (البشير حقًا) فهو حواري صادق، متبتل في محراب جمال. وقد كنت أظنه قبل معرفتي به من الذين شبّوا بين يدي جمال، وسمعوا منه وتحدثوا إليه. لكن عقودًا طوالًا تقوم بين جمال وبين بشير الذي ما زاد عمره عن الثلاثين إلا قليلًا، فأعجب! وما عندي شك أن بشيرًا قد اصطفى اصطفاءً لأداء هذه المهمة العظيمة، ذلك أن جمال، كما قال بشير، ما كان ميسورًا بلوغ عالمه حتى لمن جايله، وقد كانوا أوفر مؤونة في اللغة، فما ظنك باللاحقين وقد أصابهم الهزال اللغوي بانقطاعهم عن المتون شرّ منقطع؟ وجمال، أصلحك الله، متن في الكتابة موارٍ دفّاق.
قلتُ لبشير: حسبك من مجد ومأثرة أنك أخرجت للثقافة السودانية هذا الكنز المعرفي الضخم بإعادة نشر كتب جمال محمد أحمد في حلة جديدة بهية، تُعين قراءه قدامى وجددًا على النهل من مورده العذب. وأنت بصنيعك هذا ستجدد نهر الكتابة السودانية وقد أوشك أن يأسن. ولعلك بصنيعك هذا تحرّض الناس جميعًا على أخذ القراءة مأخذًا جادًا، فذلك ما يطلبه جمال من قارئه: أن يكون شريكه كاتبًا وقارئًا. ولعل غاية ما يرجو الكاتب فيما يصنع أن يكون له سمت معماري في الكتابة يفرده عن غيره، صنيع المهندس تقول: هذا تصميم فلان. وأن يكون لجملته ضوع وملمس، وأن يبلغ من ذلك لو أن ورقة مما خطّ رمت بها الريح تحت قدمي أحدهم، رفعها ثم قرأ، ما تردد برهة ليقول: هذا نثر فلان. وقد بلغ جمال من ذلك الغاية وزاد.
ولقد أدى بشير أبو سن دين جمال وأوفى، وأدّى واجبًا مستحقًا للثقافة السودانية بإحيائه تراث عمدة كتابها وواسطة عقد مثقفيها الكبار.
رحم الله جمال محمد أحمد، وأنزله الفراديس العليات، كم كان جميلًا.