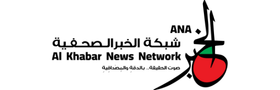محمد مسكين.. عطر الجزيرة وصوت الحنين الذي لا يذبل

بورتريه: شبكة -الخبر – في الحلة الجديدة، وتحديدًا تحت فيء “شجرة علم ود صفية” الشهيرة بظلها الفياض وعبق فطور الخالة صفية، تفتّق وعي محمد يوسف خميس، الذي حمل لاحقًا لقبًا فنيًا راسخًا: محمد مسكين. هناك، بين أصوات الباعة وأهازيج الكرة في ملاعب الحي، تمدد صوته مثل نسمة دافئة، يردد أغنيات الآخرين بعد لعب الدافوري، حتى اكتشف أصدقاؤه معدنه الأصيل وصوته الذي يقطر حنانًا.
انبثق نجمه مع مطلع الخمسينيات حين احتضنته الإذاعة السودانية مسجلًا أغنيته الخالدة من أرض المحنة، كلمات رفيق صباه وأخيه غير الشقيق الشاعر اللامع فضل الله محمد. تلك الأغنية التي تدفقت كجدول رقراق، تحتفي بود مدني وأهلها، كانت مفاتيح العشق الأولى لصوته المترف بالصدق والدفء، حتى أصبحت نشيدًا لا تخطئه آذان السودانيين.
محمد مسكين لم يكن مجرد مطرب يطارد الأضواء؛ بل كان ابن مجتمعٍ متكافل، جلس تحت ظلال أشجار الحي مع العازفين والرفاق، يقاسمهم الأحلام والأوتار، ثم سار على الدرب الطويل دون استعجال، متسلحًا بالصبر وحب الناس وإيمان لا يتزحزح بأن الفن رسالة. تدرج في سلم النجومية بهدوء، مستفيدًا من مدارس الرواد أمثال إبراهيم عوض، الذي كان له بمثابة بوصلة فنية ومفتاح للأداء الرصين.
غنى هون عليك، وقصة ريدة، وشارع الحب يا أحلى طريق، وكثيرًا من القصائد التي انتقى أزهارها من بساتين شعراء عظام: السر قدور، عبد الرحمن ود إبراهيم، محمد يوسف موسى، وغيرهم. جمع بين عذوبة الكلمة وسلاسة اللحن، فصار صوته كأنه وشاح من الشوق على أكتاف المدن.
رغم أن خطاه حملته إلى الخرطوم في الستينيات، ظل قلبه معلقًا بود مدني وأهلها، وعاد إليها مرارًا ليشاركهم الأفراح والأحزان، يشجع سيد الأتيام ويعلم أبناءه — أيمن وسوسن وأشرف — أن الفن لا ينفصل عن قيم المحبة والانتماء.
في مساء الخميس، الخامس من سبتمبر عام 2002، طوى محمد مسكين آخر حروف أغنيته في هذه الدنيا، لكنه ترك في الوجدان ما لا يموت: ألحانًا تحنو، وصوتًا يواسي، وذكرى رجل عاش بسيطًا كالماء، نقيًا كأرض الجزيرة، وأصيلًا كأهلها.
رحل محمد مسكين، وبقي صوته أنشودة تتوارثها القلوب جيلاً بعد جيل.