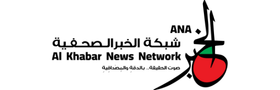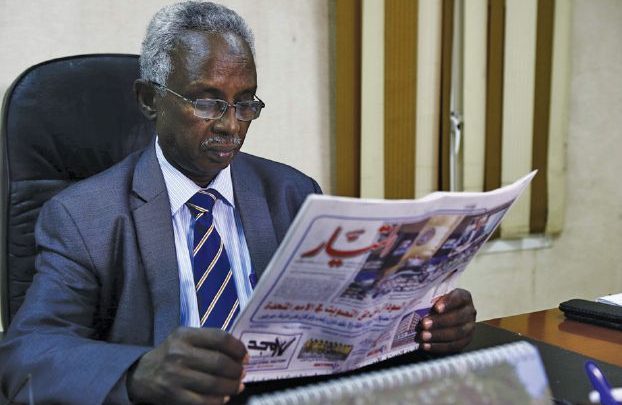السنوسي أحمد يكتب : بقايا من حرب لم تنتهِ (3)

السنوسي أحمد – أم درمان
كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة والربع ظهرًا، في الجهة الغربية من مطار الخرطوم، وعلى بُعد نحو مئتي متر جنوب المدخل الرئيسي، وتحديدًا أمام مطعم “أمواج”. كنت أقود سيارتي، عائدًا من الشارع المقابل لمقابر “فاروق”، بعد أن أتممت مهمة كلفتني بها ماريا.
الحركة في الشوارع كانت شبه متوقفة، والمدينة غارقة في طقوس الاستعداد لعيد الفطر المبارك. مررت بجوار “أبو الفاضل”، الذي بدا كأنه ملعب كرة ممتلئ بالجماهير؛ عشرات الرجال بصحبة أطفالهم، وبعضهم بدا عليه الضجر من تسوق زوجته.
حتى النساء اللائي يبعن الفول السوداني والتسالي كُنّ جالسات على الأرصفة قرب سوبرماركت “الحاوي”، يُهيئن بضاعتهن بطريقتهن الخاصة.
من بينهن “خديجة”، التي تعشق زوجتي طريقتها في تحميص الفول السوداني. كان فولها الشهي يشبه، إلى حدٍّ ما، مشروب التفاح الأخضر الذي عشقه استيف؛ من يتذوق حبة، يطلب الكيس كله.
حتى “استيف” بدا مستعدًا للعيد الذي لم يعرفه من قبل، لا احتفالًا ولا اسمًا. أعدّ مع زوجته الهادئة، التي تشبهه في الطبع والنقاء، كيكة القرع والتفاح — وصفة مشهورة في بلده — ليحتفل بها مع الأطفال المسلمين والمسيحيين الذين تؤويهم الكنيسة.
لم يكن غريبًا عليه أن يشاركهم فرحهم؛ فقد أحبهم، كما أحب هذا البلد.
ثم، فجأة، نزل شاب من سيارة قتالية تحمل لوحة بثلاثة أحرف: “ق – د – س” — باتت تُقرأ في وعينا الجمعي: قتل، دمار، سرقة. لم يكن يتجاوز السادسة عشرة من عمره.
يشبه ابني الآخر في الشكل، لا في الفعل. كأنه جاء ليشعل محرقة جديدة، تسقي أحقاده، في قلب عاصمة يكرهها ويحتقر أهلها.
لم يسأل، لم يتردد. أخرج سوطًا لا يليق لا بإنسان ولا بحيوان، وجلد به شابًا عشرينيًا طاهر القلب، كان يحاول أن يحرّك “ركشته” ليفسح الطريق لقافلة من المركبات والمعدات العسكرية القادمة من إقليم “الزُرْق”، استعدادًا لمعركة طاحنة باغتت الجميع.
من السيارة الثانية، صرخ قائده:
“اضربه تاني، ود العَذَبة/ه!”
عبارة تقطر بالاحتقار، يُطلقونها على النساء اللائي فُقنهم شجاعة وكرمًا، وتركهن أزواجهن أو قُتلوا على يد أمثالهم.
كنت أتمنى أن يكون القائد أكثر رُشدًا، أن يوبخ ذلك الصبي الذي يتلهف لإحراق مدينة تبعد آلاف الأميال عن قريته. هل كنت مثاليًا أكثر من اللازم؟ لكن، من كان يحمل السوط؟ القائد؟ أم صمته؟
تعالى صدى أغنية من سيارته الجديدة، يردد بصوتٍ ممتلئ يقول:
“مع الرشاش والمدفع، وعطر أخشامها الفوّاح.”
صرخ الشاب من الألم، فاقشعر بدني من هول المشهد. لم يجرؤ أحد من المارة أن يوقف الصبي، وهو يجلده للمرة الثالثة على ظهره النحيل.
لم يجرؤ “فارس” — الاسم الذي عرفته لاحقًا لذلك الشاب — حتى على النظر في عيني الجلّاد، الذي بدا كمن جاء لا ليحتل المدينة… بل ليحرقها، ويحرقنا معها، كما أحرق عشرات القرى في مشروع تخرجه.
كانت الأرواح الشريرة تجوب على ظهر سيارات خضراء، ليلًا ونهارًا، دون أن ننتبه — كأننا جميعًا تعرضنا لسحر… أو ربما لشيء جلبه القائد عطرون من النيجر، ليحتل به البيوت، ويسرق الحلي التي طالما سمع عنها.
في اليوم السادس، أطلق عطرون النار داخل المنزل الذي احتله، على المؤذن عبدالرحمن، بعدما رفض الأخير إيقاف الصلاة والأذان في المسجد الصغير الواقع وسط الحي.
كان عطرون حريصًا على ألا تُفسد صلوات عبدالرحمن تمائمه التي أنفق عليها كثيرًا — وقد وعد الساحر بجلب المزيد، إن صار حاكمًا لمنطقة ما.
كان كل ما يملكه الإنسان في هذه “المدينة الفاضلة” على وشك أن يُنحر. حتى الابتسامة والضحكات، ولهو الأطفال، كانت غريبة عليهم؛ لم تكن جزءًا من عالمهم، اعتادوا فقط على وحل الأحزان والمحارق.
العدو أعدّ كل شيء لحرق المدينة الطاهرة وتشريد من فيها: آلاف السيارات، مئات المدرعات، أطنان من الذخائر — بعضها رأيته للمرة الأولى في حياتي.
لكنهم نسوا شيئين، كفيلين بهزيمتهم قبل أن تبدأ المعركة: نسوا الله، ونسوا طبيعة الإنسان السوداني — تلك القاصمة التي أطاحت بأحلامهم الهمجية.
يُعد الإنسان السوداني من أبسط خلق الله، وبابتسامةٍ منك قد يمنحك كل شيء، وبـ“كلة” واحدة قد يسلبك كل شيء.
الثالث عشر من أبريل، ٢٠٢٥
لا يزال في جيبي واحد وخمسون دولارًا، طُبعت فئة الخمسين منها في العام 2007، وتحمل الرقم التسلسلي 1978345. قد أنساها، أو تختلط ببعض الأموال الأخرى، لكنها تعود إلى أطفال كنيسة “سانت ماثيو” — مسيحيين ومسلمين — أعطاني إياها استيف في اليوم الذي غادر فيه السودان دون رجعة.
كان ينوي في الثالث عشر من أبريل 2023، بعد انتهاء التوزيع، أن يشتري بها خبزًا لهم، مع ما في ذلك الكيس الأسود. لكنه نسي، عندما وقف مسرعًا في طريق عودته إلى المنزل، مع السائق الذي يُعرف بـ“بروسلي”.
تحولت كنيسة سانت ماثيو إلى خراب؛ إلى مكان يشبه منزل ياسر، الذي دنسه القائد عطرون، بعدما فشل في التأقلم مع تحوّله من التبرز في الخلاء إلى حمام “إفرنجي” كالذي رآه في الصحف الفرنسية، ولم يتعلم لغتها أبدًا بسبب حقده.
كان يقضي حاجته في كل شبر من المنزل، خصوصًا في أيامه الماجنة مع الفتيات المختطفات من قِبل أحد جنوده، الذي كان يأمل شفاعة عطرون ليقاسمه “مقتنيات ياسر” — أو كما سموها: “غنائم حرب”.
لم تسلم الفسيفساء الجميلة، ولا الزجاج المعشّق، ولا المذبح العتيق الذي تجاوز عمره المئة عام — تلك العناصر التي كانت، بألوانها الزاهية، تحكي قصة السودان: تنوّعه، وخصوبته، والعاصمة التي أحرقها الأوباش.
ربما كان ذاك الصبي، عاشق المجازر، هو من أضرم النار في الكنيسة؛ نفس الصبي الذي جلد جسد فارس النحيل. لم يبقَ منها سوى فجوة صغيرة، يمكنك النظر عبرها إلى السماء… وإلى منزل ماريا في الشارع المقابل، الذي لم يسلم هو الآخر.
أحرق الأوباش الأريكة الخشبية الطويلة التي صُنعت من شجر المهوقني، وجلس عليها استيف قبل أسبوع، يدعو الله أن يعمّ السلام. أحرقوا العشرات مثلها، لطهو الطعام بعد أن نهبوا كل شيء من المكاتب والمطاعم المجاورة. أحرقوها لتدفئة أجسادهم القذرة من صقيع الخرطوم، الذي لم يعتادوه.
صرنا جميعًا ضحايا غوغائيتهم، ضحايا ولعهم بالمحارق والفظائع. لم يُشفع لأيٍّ منّا اختلاف العقيدة، أو القبيلة، أو حتى مسقط الرأس — صرنا ضحايا فقط لأننا سودانيون. لا جسدًا، بل روحًا.
مثل ماريا واستيف؛ أجانب على الورق، سودانيون في الروح وحتى أنا، لم أسلم، رغم أنني أنتمي إلى أكثر من عشرة أوطان، ربما أكثر، إن أضفت بدويّتي.
لعلّ السودان على رأس تلك الأرواح النقية التي أبغضها السمج عطرون، وحاول أن يحرقها وفشل — لأنه لم يدرك أن الأرواح لا تُحرق، ولا تموت؛ بل ترحل مثل الطيور، لتعود أصلب حين تصفو النفوس، لا حين تزول فقط رائحة الموت عن المدينة. وبالأخص تلك التي وُلدت من طمي النيل… فهي لا تفنى، بل تتجدد كلما نادى الوطن.
يُتبع…