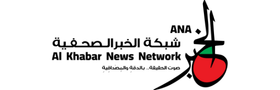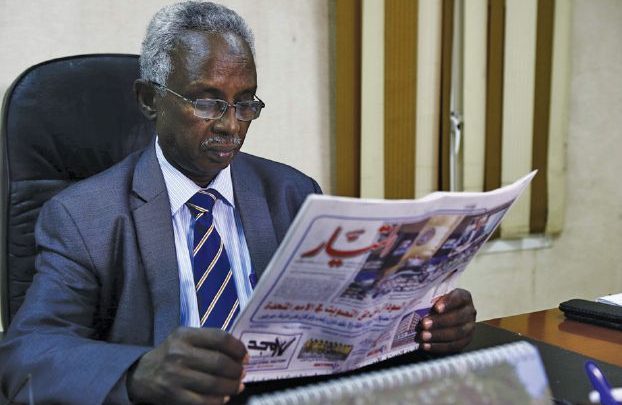السنوسي أحمد يكتب : بقايا من حرب لم تنتهِ (2)

السنوسي أحمد – أم درمان
في الثالث عشر من أبريل 2023، في الجهة الشمالية الشرقية من مطار الخرطوم، وعلى مقربة من محطة النحلة للوقود، كانت الساعة تقترب من الخامسة والنصف مساءً. وزعت جهة خيرية أكثر من 500 وجبة على عابري الطريق، ولم يتبقَّ سوى عشرة أو أحد عشر صندوقًا، إلى جانب بعض قوارير المياه.
كان ياسر، بابتسامته المعتادة ووجهه الوضّاء، يقف وسط الطريق الذي خفّ فيه الزحام، يلهج بالشكر والحمد لله، ممتنًا للنعمة التي يعيشها ولسعادته بكونه أحد المتطوعين في توزيع الطعام.
قال في ابتهال صادق:
“يا الله، يا مالك السماوات والأرض، اجعلني دومًا في رحمتك، وامنحني رضاك. اللهم اجعلني من أهل الخير، واحفظ أمي، وارحم أبي.”
راقبته عن بُعد، ولم أشأ أن أقطع عليه لحظة الصفاء تلك قبيل الإفطار. كان دعاؤه نقيًا، يخرج من قلبٍ طيبٍ مملوء بالبركة. أخرج منديلاً من جيبه الأيسر، ومسح دمعة انزلقت من عينه في خلوته مع الله.
ياسر من أصدق وأشجع من عرفت. من اللقاء الأول تشعر بالندم لأنك لم تعرفه من قبل، حين كنت تبحث عن نصيحة نابعة من قلب نقي.
كان واسع المعرفة، من العقارات والسيارات إلى خبايا السياسة وفساد بعض ساستها، الذين طالما حذّر منهم.
كان يردّد دومًا:
“أنا من بحري قبل أن أكون من السودان.”
يدّعي أنه ينتمي إلى مدينة فاضلة، كل ما فيها جميل.
يعشق منزلهم بجنون، بكل تفاصيله، بكل ما يربطه بالمكان.
أحيانًا كنت أراقبه خلسة وهو يتأمل البيت في منتصف النهار، عبر الكاميرا التي اشتراها من بيتر وسط السوق العربي، المتصلة بالهاتف.
صمد في بيته قرابة أسبوع منذ اندلاع الحرب، سعى جاهدًا للبقاء أطول، لكن القدر لم يمهله. كعادته، كان خائفًا على أسرته الصغيرة، وعلى أمه التي يحبها بلا حدود.
كان على استعداد لفعل أي شيء… وفعل.
غادر على عجل، دون تردد، محمولًا بقلبه ودمه.
قال لي ذات مرة:
“ما كنت أتصور أن أغادر دون أن أعود…”
لم يكن أحد يعلم كم ستطول هذه الحرب اللعينة، حتى ياسر، الذي قلّما يخطئ، عجز عن التنبؤ.
لم يكن يعلم أن “القائد عطرون” — الشيطان القادم من النيجر — سيحوّل ذلك المنزل الجميل والعامر بالحب إلى معتقل ومكتب لإذلال الأبرياء. دنّس عطرون المكان بكل ما فيه من حقدٍ وغِلّ.
ناديت على ياسر لنعود معًا استعدادًا للإفطار. مشينا سويًا نحو عشر دقائق. كانت تلك آخر مرة رأيته فيها… لكنها كانت المرة الأولى التي عرفته فيها حقًا.
كعادتي الغريبة، حضرت المكان بطابع بدوي، لا يشبه من حولي. طبيعتي الريفية دومًا تتغلّب على كل مظاهر الحداثة التي تحيطني.
أحب أن أعيش الغد في الأمس، لا خوفًا من المستقبل، بل حبًا لذاك الماضي الذي يذكّرني بأبي.
جلس ياسر بجوار استيف، أحد المشاركين في التوزيع، الذي كان يصلي ويدعو الله أن يحفظ السودان.
بدت على استيف علامات التوتر، يتابع الأخبار من قناة الجزيرة بقلق ظاهر. إلى جواره حقيبة بلاستيكية كبيرة لم يفارقها لحظة. لم يعلم أحد ما بداخلها… سواي.
كان ينوي المرور على كنيسة “سانت ماثيو” بشارع النيل، قرب العمارة الكويتية، للقاء أطفال يعرفونه جيدًا، بوجهه الطيب وقلبه النقي. كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر للتحدث معه بالإنجليزية التي تعلموها للتو.
استيف، الذي لم يُكمل ثلاثة أشهر في السودان، وقع في غرام هذا البلد الساحر. حتى زوجته لم تنجُ من فتنة الأرواح النوبية والفونجاوية. كان يحب السودان بجنون.
وكنت أتساءل أحيانًا:
هل سيعود استيف إلى بلاده بعد أن يُتمّ سنواته الثلاث؟
أم سيبقى في وطنه الجديد، الذي اختاره قلبه دون استئذان؟
أخرجت من الحافظة التي خبأتها قبل التوزيع مشروب التفاح الأخضر، وناولته له. وقبل أن يُنهيه، سألني إن كان هناك علبة أخرى. كنت أتوقع ذلك… فناولته الثانية.
أخذها معه إلى البيت… لكن يا للقدر! لم يشربها. اضطر، كغيره، إلى مغادرة بلده الثاني على عجل، تاركًا كل شيء… عدا الذكريات.
لكنه، بخلاف ياسر، ترك وراءه شيئًا أعمق… ثلاثة أشهر لم يشبع فيها من السودان.
رنّ هاتفي…
المتصلة: ماريا، يونانية سودانية، لم تكن يومًا يونانية سوى في الأوراق. كل ما فيها ينتمي إلى السودان.
زوجها توني، بملامحه الأوروبية، يشبه في سودانيته أهل الجزيرة الطيبين أكثر من اليونان. لا تفارقه الابتسامة، وأحيانًا هو أكثر من عرفت سخريةً ومرحًا.
ماريا كانت تعاملني كابنها البكر. كادت أن تتبناني لتكون لي أمًّا ثانية.
مازحتها يومًا:
“هل تتبنين ابنًا بأبناء؟”
“سأكون جدة رائعة! سأطبخ لهم من قلبي، سأعدّ لهم اللازنيا التي تحبها.”
قالت ماريا…
يُتبع